منصورة عز الدين
كلما حاولت
الكتابة عن الفنان جودة خليفة أو "عم جودة" –كما اعتدت مناداته- أتوه
بينما أبحث عن طرف خيط للبدء منه. الذكريات كثيرة، والحكايات الصغيرة أكثر،
والتفاصيل والمواقف المشتركة بدلاً من أن تقودني لما أريد قوله، أجدني أتعثر فيها
وأنا أخطو في دروب الذاكرة.
لطالما ظننت
أن ثراء شخصيته وحضوره العاصف والملهم في آن هما ما يتحديان القدرة على اختزالهما
في كلمات، وهو ظن سليم يضاف إليه سبب كان كامناً ولم أنتبه إليه إلّا عندما بدأت
في استحضار عم جودة عبر الكتابة، وهو أني – شئت أم أبيت – سأكون حاضرة في أي نص
أكتبه عنه، سيكون ملوناً بذاتية مفرطة أتحاشاها وأهرب منها، والسبب في هذا أن
صداقتي معه أو بالأحرى أبوته المعنوية لي كانت في مساحة الشخصي والذاتي أكثر منها
في العملي والإبداعي. الأمر الثالث هو أن فكرة الكتابة عنه، عنت بالنسبة لي تأبينه
والاعتراف بموته.
فعلى منوال
مقولة جان جاك روسو "الحرف يميت"، لطالما شعرت أن تحويل "عم جودة
خليفة" بكل حيويته وإقباله على الحياة والآخرين إلى حروف وكلمات هو حصر له في
مساحة ميتة مهما بلغ عنفوان اللغة التي تقاربه.
بالنسبة لي
هو ما زال يمارس هوايته في المشي في مكان ما غير مرئي، في مصادقة الطرق والعيش
فيها كأنها بيته البديل ومحور وجوده. من أراد لحياته أن تكون سلسلة من المشاوير
المتتالية، كأن المشي هو غايته في الحياة ووسيلته للتوازن والانسجام مع العالم، لا
يمكنه الكف عنه، وإذا كانت جنة كل منا تُرسم على مقاس أحلامه وتفضيلاته لكانت جنة
عم جودة مدينة عامرة بالطرقات كي يتاح له المشي فيها كما يشاء.
فرغم أنه
وُلِد في ريف الشرقية وانتقل للقاهرة للدراسة والعمل إلاّ أن المدينة بتشابكها
تلائمه أكثر. في حالته يتلاشى التصنيف المعتاد في تقسيم البشر إلى أبناء ريف
وأبناء مدن، فقد كان ابناً للطريق أي طريق وكل طريق.
لم يكن يتكلم
معي عن قريته التي جاء منها إلاّ لماماً، جمل عابرة ناتئة وسط حدوتة شائقة يحكيها، فتبدو تلك القرية كأنما خارج عالمه، ويبدو لي شخصاً يصعب حصره في مكان ضيق. في
المقابل كان يجد نفسه في ساحات المدينة وأزقتها فلا تشك للحظة أنه غريب عنها،
ناسبته المدينة أكثر لأنها أتاحت له التجول والتوحد بالطرقات محروساً بالحرية التي
تتيحها المدن الكبيرة للسائرين في دروبها وبين حناياها.. في مدينة كبيرة كالقاهرة كان
يمكنه أن يطوف ويجول كما يحلو له. يعبر الأشياء والمعالم وتعبره. يصافحها سريعاً
منتقلاً إلى غيرها بكامل حريته وانطلاقه دونما التزام تجاه شيء معين أو مكان
بعينه. لا يملك شيئاً فلا يملكه شيء.
أفكر الآن أن
علاقتنا بالمشي والطرقات – على اختلافها – هي ما جمع بيننا.
كنا في أواخر
التسعينيات عندما تعرفت عليه لأول مرة. وقتذاك كان المشي في شوارع القاهرة هوايتي
الأولى. تسكع يمتد لساعات تقطعه جلسات قصيرة في محطة أتوبيس أتأمل خلالها
المنتظرين والمارة، أو ركوب أتوبيس لا تهمني وجهته الأخيرة بقدر ما أهتم بأن يكفل
لي مساره أكبر قدر ممكن من مناظر وتفاصيل متنوعة أختزنها كجمل يخزن الماء والدهون
الفائضة عن حاجته.
باختصار كنت
أتسكع بلا وجهة محددة، كأنني فقط أرسم بخطوتي خارطة المدينة التي أريدها، وأحفر
لنفسي موطئ قدم فيها في الوقت نفسه، فيما كان مشيه هو أقرب لطقس صوفي هو فيه شيخ
الطريقة والمريد معاً. كنت وحيدة، حريصة على وحدتي وعلى عدم مد جذوري في المكان. أظهر فجأة وأختفي فجأة متحاشية أي التزامات أو قيود، وكان يسير في مدينة يحفظها عن
ظهر قلب وله في كل ركن فيها مكان وصحبة، مدينة تكف في حالته عن أن تكون عدة مدن في
واحدة، وتصبح بحجم راحة اليد. في يوم واحد ينتقل من وسط البلد إلى مصر الجديدة، ومن
"حوش قدم" إلى الزمالك، قبل أن يعود إلى مسكنه في مدينة نصر. كان يتوقف
فجأة ليسألني: "عايزة تشوفي ريف في وسط البلد؟"، أو "تعرفي أقدم
شخص بيبع فوانيس في القاهرة؟". قد يحكي حكاية كازينو "تريومف"، أو
مطعم "الأمفتريون"، أو يقترح أن يعرفني على المثَّال التلقائي محمود
اللبّان، أو يمنحني مجلد أعمال فنان الكاريكاتير حجازي بإهداء خاص من حجازي. وقد
يفاجئني بأعمال لابن عربي والنفري والتوحيدي مشددا على أهمية القراءة لهم. وحين
أشكره يغضب قائلاً إنه لا يفعل أكثر مما فعل أمثال أحمد بهاء الدين وحسن فؤاد مع
جيله.
***
عندما كنت
أواظب على السير في طرقات القاهرة وحدي، لم أكن أعرف أن "عم جودة" ربما
كان يمشي في الوقت عينه في الشوارع نفسها التي أمر بها، وأن خطوتي قد تكون تقاطعت
مع خطوته في مفترق طرق ما قبل أن نتعارف.
أثناء دراستي
الجامعية، كنت أصادف رسوماته على أغلفة "أخبار الأدب" أو صفحاتها
الداخلية، كما على أغلفة وصفحات مجلات غيرها. زميلي في كلية "الإعلام"،
وليد رشاد، كان يحكي عنه باستمرار باعتباره قريباً له، ولوحاته الداخلية في إحدى
مجموعات محمد البساطي القصصية صارت جزءاً أساسياً من تلقي نصوصها بالنسبة لي.
ثم قابلته في
مجلة "الأهرام العربي" حين كنت أتدرب في قسمها الثقافي تحت إشراف
الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي. ما أتذكره عن هذا اللقاء أن حضور "عم
جودة" التلقائي المناقض لمزاج "الأهرام" المتحفظ والرسمي قد أضفى
على المكان حيوية وصخباً نادرين فَعَلَت الضحكات وعمّ جو احتفالي تحول فيه الكلام،
مجرد الكلام، إلى فن ينافس الفنون الإبداعية الأخرى.
قيل لي يومها
إنه ينسى أسماء من يتعرف عليهم حديثاً لأنه مكتفٍ بصداقاته القديمة، يقابل الجميع
بمحبة كأنها موجهة إلى الكون بكامله لا إلى هذا الشخص بعينه، وفي هذه الحالة من
يحتاج إلى الأسماء؟!
بمصادفة بحتة
رأيته في ميدان الألفي بعدها بأيام، وفوجئت بأنه يتذكرني، تحدثنا لبعض الوقت في
أحد المقاهي هناك، لكن المعرفة لم تبدأ في التعمق إلّا حين جمعتنا جلسة ضمت كثيرين
في مقهى معرض القاهرة للكتاب، يومها كان النقاش حامياً بخصوص مَن يكتب التاريخ؟ والتبسيط المخل
في مقاربة حركات وتحولات تاريخية مهمة، وكان هو يتابع في المساحة الفاصلة بين
الاهتمام والضجر دون أن يتخلى عن دعاباته وملاحظاته الذكية التي لم يكن لها أدنى علاقة
بموضوع النقاش ومن هنا نبعت طرافتها وعبثيتها بالنسبة لي.
مع تخرجي في
الجامعة وبداية بحثي عن عمل كانت معرفتي بعم جودة قد توثقت لدرجة أصبح معها أبي
الروحي وأثق أنه كان كذلك لآخرين ممن كانوا محظوظين كفاية بالتعرف عليه عن قرب.
فإضافة إلى نبله وكرمه على المستوى الإنساني، وموهبته وإخلاصه كفنان، كان موسوعة تسير على قدمين، أتاحت له تجاربه
الاطلاع على خبرات يصعب توافرها في شخص واحد، خبرات لم يكن يبخل بها على من
يحتاجها دون أن يقوم بدور الناصح أو الواعظ الممل.
حين عملت في
التلفزيون المصري لشهور في أواخر التسعينيات، كنت أتجه، ما إن أغادر مبنى ماسبيرو،
إلى مقر عمل "عم جودة" في مجلة أكتوبر، التي لا تبعد عن ماسبيرو سوى
خطوات. مشوار شبه يومي حرصت عليه، ننطلق
بعده للمشي في شوارع القاهرة، دائما ما كان يسبقني بخطوات ثم يتوقف منتظراً إياي
فيما أسرع للحاق به.
ثمة دوماً مهام كان عليه الانتهاء منها قبل التفرغ للسير باستغراق من يؤدي طقساً روحياً: تصوير رسوماته الجديدة، ثم المرور على بعض المجلات والجرائد لتسليم لوحات مطلوبة منه أو للقاء أصدقاء له. معه لا أبواب مغلقة الكل يتهلل فرحاً برؤيته، وهو يوزع سخريته وضحكاته متحدياً أي أحزان أو آلام محتملة. كان يسير محاطاً بحب كل من يعرفونه على اختلاف شخصياتهم وطباعهم، ربما لأنه لا يضع نفسه في موضع الصراع مع أحد. كان زاهداً فيما يتصارع الآخرون عليه، يكفيه أن يرسم كما يحب، وأن يترك نفسه للتجوال الحر في الشوارع والجلوس في مقاهٍ لا حصر لها، يشرب شايه، ويتبادل الحديث مع مرافقين يدهشك أن بعضهم يراه للمرة الأولى، ومع هذا يعاملهم كأصدقاء عمر، وينهي كلامه بـ"لازمة" قلما تتغير: "بس خلاص"!
ثمة دوماً مهام كان عليه الانتهاء منها قبل التفرغ للسير باستغراق من يؤدي طقساً روحياً: تصوير رسوماته الجديدة، ثم المرور على بعض المجلات والجرائد لتسليم لوحات مطلوبة منه أو للقاء أصدقاء له. معه لا أبواب مغلقة الكل يتهلل فرحاً برؤيته، وهو يوزع سخريته وضحكاته متحدياً أي أحزان أو آلام محتملة. كان يسير محاطاً بحب كل من يعرفونه على اختلاف شخصياتهم وطباعهم، ربما لأنه لا يضع نفسه في موضع الصراع مع أحد. كان زاهداً فيما يتصارع الآخرون عليه، يكفيه أن يرسم كما يحب، وأن يترك نفسه للتجوال الحر في الشوارع والجلوس في مقاهٍ لا حصر لها، يشرب شايه، ويتبادل الحديث مع مرافقين يدهشك أن بعضهم يراه للمرة الأولى، ومع هذا يعاملهم كأصدقاء عمر، وينهي كلامه بـ"لازمة" قلما تتغير: "بس خلاص"!
هل أضيف إنه
كان يحتقر المال والنجاح؟! لا أعتقد أن "يحتقر" هي الكلمة الملائمة،
فالاحتقار يتطلب درجة ما من الاهتمام، وهو لم يكن يكترث بكل ما يلهث الجميع خلفه.
أتذكر أني طالبته مراراً بإقامة معرض لرسوماته الصحفية، فكان يرد بضحكة أكاد
أسمعها بينما أكتب هذه السطور، ضحكة طويلة تقع على أذني كسؤال مضمر: معرض مرة
واحدة، ليه؟! لحظتها أوقن أني لن أجد جواباً يقنعه.
"انجحي
بالتقسيط، نحن في بلد يؤذيه أن ينجح أحد"! كان يقول من وقت لآخر، فأسأله،
وكنت لم أنشر سوى قصصاً متفرقة: وهل يتحكم أحد في نجاحه من عدمه؟!
فيحكي حكايات
سريعة تشرح نصيحته وتفصلها.
***
لقائي الأخير
بعم جودة كان في مستشفى السلام الدولي، حين ذهبت مع الصديق محمد شعير لزيارته قبل
وفاته بوقت قليل. هناك كان متعباً وضجراً وخُيل إلي أن علاجه يكمن في الانطلاق
مجدداً في شوارع المدينة وميادينها هرباً من شبح المرض الخبيث وتحدياً له.
مشاهد عديدة
تتتالى على ذهني حين أتذكره الآن، شذرات متفرقة أشبه بوعد مخاتل بكتابات قادمة عن
فنان وإنسان استثنائي أدين له بالكثير وصديق لن أجد من يماثله أو يملأ الفراغ الذي
تركه.
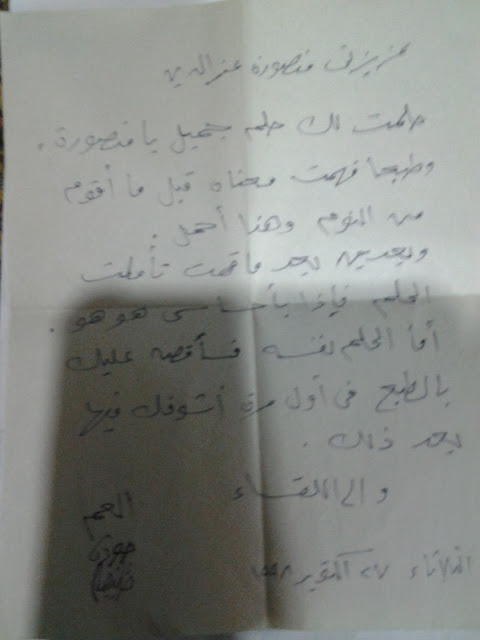
No comments:
Post a Comment